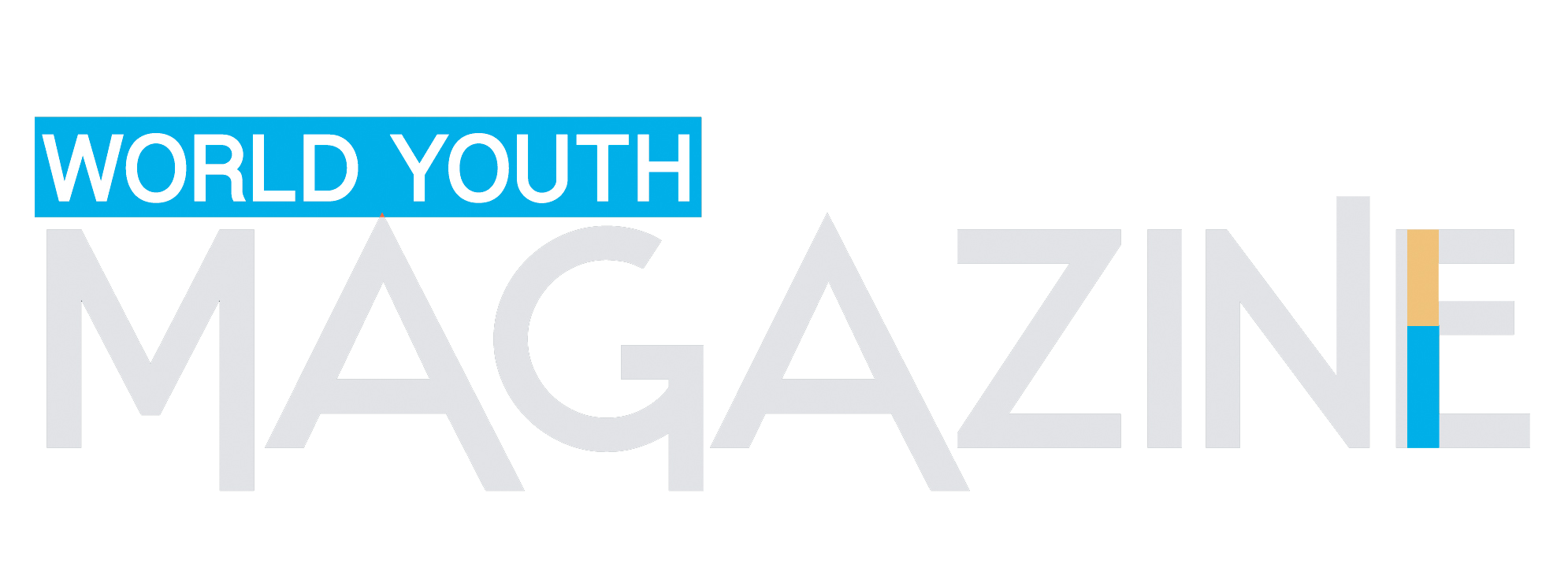بالعربى
اختلفت الأدوات والسلام والإنسانية تجمعنا

عادة ما ترتبط أوضاع الاضطراب والحروب بصور العنف والحداد يغزيها وقود التطرف والتعصب.. تتهدم منازل كانت آمنة وتعلو مدن كاملة من الخيم، يهجر المواطن إلي حيث لا وجهة محددة، تغطي أصوات القذائف والعويل على غيرها من الأصوات، يصبح الإنسان فى المحصلة “غير مرئي” وتنسحب قيم السلام والإنسانية والتعايش للخلفية باعتباراها أمور ثانوية.
في حالات الفوضي، ترتفع الأصولية بأدواتها السيئة، تتنوع أشكال الموت والتشرد، يضيع السلام، وتفقد البشرية أمنها وأمانها. لكن يبقي “الخير فى الأنسان” ما دامت الحياة سائرة، تظهر طاقات النور والأمل، يسخر بعض الأفراد قدراتهم البسيطة خدمة لأشقائهم فى الإنسانية، دون تفريق بين لون أو دين أو عرق، متلحفين بتعاليم “الدين الإنساني” التى يبقي جوهره وفق تعبير المهاتما غاندي “فتشت عن الاديان فوجدت عمل الخير ديني”، هذا ما يؤكده التاريخ البشري والمساعي المتسمرة داخل مجتمعات الأرض باختلاف جغرافيتها.
الأديان والدعوة للسلام
قبل التطرق إلي بعض من الأعمال الإنسانية والمبادرات التى حققت رقما فى إعادة بناء السلام والأمن والتعايش فى مجتماعتهم، يبقي من الأهمية دحض ما يروج له خطاً أن التطرف والعنف والهدم والدمار يمكن أن يكون باسم أي دين سماوي.
فالأصل فى تلك الأديان هو الدعوة للتسامح والسلام والبناء والتعمير، الخير أساس رسالته، والعيش المشترك جوهر استمراريته، إذ يقول الله تعالى في قرآنه الكريم في سورة الحشر “هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ”، وفي رسالة بولس “رَبُّ السَّلاَمِ نَفْسُهُ يُعْطِيكُمُ السَّلاَمَ دَائِماً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. الرَّبُّ مَعَ جَمِيعِكُمْ” وفي إنجيل لوقا “الْمَجْدُ للهِ فِي الأَعَالِي، وَعَلَى الأَرْضِ السَّلاَمُ، وَبِالنَّاسِ الْمَسَرَّةُ”.
إذا فلماذ العنف والتطرف والإرهاب يبقي حاضرا؟ هذه ليست مسألة يمكن تجاوزها قفزا فوق حقائق عالمنا وتفاعلاته عبر الأزمان والأماكن، فـ”كل شئ وارد وكل خيار متاح”، لكن تبقي العزيمة والإرداة هم وحدهم القادرين على إدخال الخير إلي قطار الحياة.
“أشبال الخلافة” وإعادة التأهيل
في كتابه “يقاتلون كالجنود يموتون كالأطفال”، يصف الجنرال السابق في قوات حفظ السلام في الكونغو بعد حربها الأهلية، روميو دالير، الأطفال بأنهم “السلاح الأمثل في الحروب”. وبحسب دالير، يبدي الأطفال قابلية لتعلم أشياء جديدة أكثر من البالغين، وتكلفة إعدادهم قليلة مقارنة بالأكبر منهم سناً. كما يبدون ميلاً إلى الطاعة سواء بدافع الخوف أو الترغيب، ويتمتعون بخفة في الحركة تتيح لهم التنقل براحة في الجبهة، يستعملون كأدوات جنسية ودروع بشرية، ومن هنا تكمن المأساة بعد أن تضع الحرب أوزارها.
فى مكان ما فى شمال شرق سوريا، وقرب الحدود العراقية، فى بلدة تل معروفة بمحافظة الحسكة، تروي روكن خليل (35 عام)، أحد المسؤولين عن مركز “هوري” لإعادة تأهيل أطفال “داعش” بعد دحر التنظيم من مناطق سيطرته فى سوريا والعراق، كيف أن قنبلة ما بات يعرف بـ”أشبال الخلافة” يمكن أن تلقي بشظاياها على كل دول العالم دون استثناء.
بحسب خليل فإنها “والعشرات من المتطوعين فى ذلك المركز يعملون منذ العام 2017 على إعادة تأهيل الأطفال ومحاولة دمجهم مجددا بعد المشاهد المروعة التى تربو عليها”، متذكرة “كيف أن أحد أبناء قادة التنظيم وهوو يبلغ من العمر 13 عام قبض عليه وهو يحمل رأسا مقطوعة فى يده”.
فكرة خليل فى إعادة التأهيل، التى لم تكن الوحيدة التى تتعاطي مع محاولة بناء المجتمعات فى سوريا والعراق، ما بعد “داعش”، لكنها تبقي ملهمة لتركيزه على الأطفال ما بعد مراحل التطرف. وتروي قائلة: “لدينا أكثر من 100 طفل فى مركز إعادة التأهيل تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 عام بعضهم شاهد العديد من عمليات ذبح البشر، وأن بعض هؤلاء ينتمون لداعش وقد يكونوا في السجون، وبعضهم الآخر جندته داعش طوعاً أو قسراً”.
ووفق خليل: “يخضع الأطفال لبرنامج يومي مكثف يشمل الكثير من الرياضة والأعمال المنزلية، والمشاركة في ورش عمل حيث يتدربون على مهن مختلفة، فضلا عن تلقيهم دروساً في التاريخ والجغرافيا إضافة إلى دروس في الأخلاق”.
وتتذكر خليل، الأيام الأولي بعض هؤلاء الأطفال لدي وصولهم مركز التأهيل، وكيف كانت حال بعضهم “إذ لم يلقوا التحية أو يسلموا علينا باليد، ولا حتى ينظرون مباشرة إلى وجوهنا”. مقرة فى الوقت ذاته إن “علينا اعتبارهم بشر وضحايا لهذه الحروب”.
وعن نتائج المبادرة، تروي خليل كيف تغير سلوك العديد من الأطفال على مدار أشهر من التأهيل، قائلة: “بات الأطفال يبادرون من تلقاء أنفسهم للحديث معنا، ولم يعد الكثير منهم يوجه الشتائم لزملائه عند وقوع خلاف بينهم، بل أصبحوا يستمعون إلى الموسيقى”.
رحلة للبحث عن حياة
علي وقع أزمة الهجرة واللجوء التى تفجرت فى أوروبا إثر اضطرابات منطقة الشرق الأوسط ومنها الأزمة السورية، وما تبعها من تصاعد نبرات العنصرية والتطرف لرفض استقبالهم “الوافدون الجدد” لتلك المجتمعات، يروي الشاب الإيطالي سيموني سكوتا (33 سنة)، والذي يعمل في مكتب اتحاد الكنائس الإنجيلية، حيث يساعد في اختيار اللاجئين لللانتقال للدول الأوروبية، “كيف أن بعض اللاجئين فقدوا منازلهم، وآخرون فقدوا أفراد عائلاتهم، وبعضهم تعرض للسجن والتعذيب، أو يعاني من مشاكل صحية… ولكنه رغم المآسي التي يعايشها، فإن سعادته تكمن في تمكين الناس من بدء حياة جديدة”.
سكوتا، حاكياً قائلاً: “كنت ضمن القائمين على مبادرة الممرات الإنسانية التى تأسست في إيطاليا بعد حادثة انقلاب قارب يحمل لاجئين ومهاجرين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا في 3 أكتوبر 2013، حيث لاقى أكثر من 300 شخص حتفهم، حيث اجتمع ائتلافاً من المنظمات الدينية مع وزارات الداخلية والخارجية، وتم اطلاقها”. وبتابع: “منذ انطلاق البرنامج في خضم أزمة اللجوء والهجرة إلي أوروبا، تم نقل أكثر من 2,000 لاجئ من الفئات الأكثر ضعفاً إلى إيطاليا أغلبهم لاجئون سوريون وإريتريون أتوا من لبنان وإثيوبيا والأردن والنيجر”.
وبحسب سكوتا، هنالك أعداد متزايدة من اللاجئين الذين يعدون من الفئات الأكثر ضعفاً، وليس بإمكانهم البقاء في البلدان المضيفة لهم، ولهذا السبب تتمتع برامج الكفالة مثل برنامج ”الممرات الإنسانية“ بأهمية كبرى، إذ أنها تمثل شريان حياة لأشخاص معرضين لمخاطر كبرى، علي حد تعبيره، قائلا: “اللحظة التي تشعرني بأقصى قدر من السعادة، هي لحظة إقلاع الطائرة ثم وصولها… فنحن نعرف الظروف التي عاشها اللاجئون في سوريا ولبنان… وأعتقد بأن منحهم فرصة ثانية أمر منصف”.
سعياً لإعادة اليمن “سعيداً”
من سوريا والعراق إلي اليمن، حيث دفعت الأوضاع الإنسانية الصعبة بمجموعة من الشباب في العاصمة صنعاء إلى إطلاق بعض الطلبة والطالبات مبادرة “رواد الإنسانية”، التي تسعى للحد من معاناة المواطنين وتطوير العمل التطوعي، بهدف “مساعدة الفئات المستضعفة وتعزيز روح الانتماء والولاء في أوساط الناس والشباب تجاه مجتمعاتهم”.
يقول عصام الأحمدي، أحد القائمين علي تلك المبادرة، إن الفكرة بدأت لدي 16 طالب وطالبة من جامعة صنعاء فى مارس 2016، للعمل معاً نحو إمكانية مساعدة المواطنين وتحسن ظروف عيشهم، مع التركيز علي النازحون والمرضي وأسر وأطفال المتضررون والمعاقون، وقد تمكنوا وفق تعبيره على “تحقيق نجاحات قياسية”.
يروي الأحمدي، وهي الخريج حديثا من جامعة العاصمة، كيف تمكنت المبادرة من مساعدة أكثر من 100 أسرة من توفير للغذاء ومواد طبية وإعانات مالية وإيجارات مساكن، قائلاً: “رغم العراقيل تمكنا من مساعدة العشرات بل المئات حيث تكفل بها فاعلو خير”.
ويتذكر الأحمدي، كيف أن المنظمات الدولية الكبري تخلت عن دعمهم، لكن بقيت العزيمة والإرادة والإحساس بمعاناة المواطنين هو المحرك الرئيسي فى استمرار عملهم. ويتابع: “عدم وجود مصدر تمويل ثابت ونقص الإمكانيات أبرز الصعوبات التي تواجهنا، لكننا مصرون على استكمال عملنا وغالباً يتكفل كل عضو بمصروفاته”. وعلي مدار السنوات الأربع الأخيرة، ومنذ اندلاع الحرب فى اليمن عام 2015، ظهرت العديد من المبادرات الفردية والجماعية من هذا النوع، لمساعدة ضحايا الصراع المستمر.
من رحم المعاناة تتولد الحلول
وفي شكل أخر من البحث عن المشتركات وإعلاء قيم السلام والتنمية، يروي عبد المهدي عدنان غريب، ذي الـ25 ربيعا، كيف يسعي ومجموعة من أبناء جيله فى مساعدة المتضررين من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتواصل فى المنطقة دون حل منذ أكثر من 7 عقود.
وبحسب غريب، فإن تجربته فى العمل الإنساني بدأت عام 2008، من خلال جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينة، حيث كان ابن 14 عام، وقام من خلال القائمين على تلك الجمعية العمل علي مساعدة الناس في قطف الزيتون ومساعدة من هدمت بيوتهم.
ويتذكر غريب، كيف تحول تباعا ليكون مسؤولا عن التنسيق فى الفريق التطوعي لمساعدة المتضررين قلا مخيمه في فلسطين، قائلاً: “كانت أول مبادرة قوية في منطقة سكني مخيم دهيشة بداخل الأراضي المحتلة، في حالات الاشتباكات بين الفلسطينين والإسرائيلين، عادة لا تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلي المصابين نتيجة ضيق الشوارع وكثافة الغازات”.
ثم يتابع: “تبادرت إلينا فكرة تدريب فريق إسعاف أولي فى مناطق الإشتباكات والتى يصعب الوصول إليها، لإسعاف المصابين بشكل ميداني، وبالفعل تمكنا من مساعدة الآلاف”. وبحسب غريب، فإن أكبر التحديات التى واجهته، هي تلك المتعلقة بمحاول استهداف المسعفين الميدانيين فى الصراع بشكل متعمد، موضحاً: “فى مخيمي فقط أصيب نحو 18 مسعف وقتل واحد خلال عام 2019، رغم أن أهدافنا تتركز فقط علي انقاذ حياة العديد من الناس”.
ويروي غريب، كيف كبرت فكرة تدريب فريق إسعاف مدنيين، وباتت مبادرته وحدها “مسؤولة عن ١٤ فريق اسعاف يغطي جميع أنحاء المحافظة”. مضيفا أن “تلك الفرق التى تم تشكيها صارت تساعد وتعمل علي أي نشاط إنساني او مجتمعي بالمنطقة”. معتبراً: “إذا تمكنا من إحداث التغيير عبر الشباب سيعم على كل الوطن لأننا أمة بالأساس قوامها الشباب”.